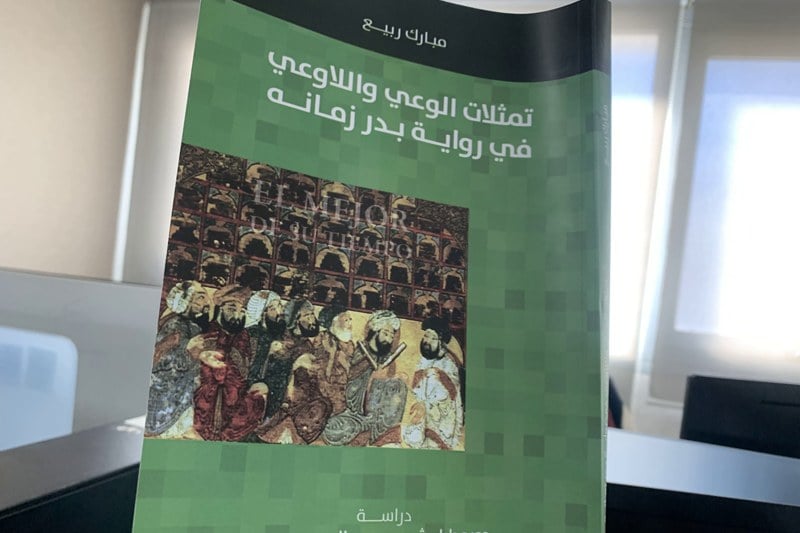بعنوان “تمثلات الوعي واللاوعي في رواية بدر زمانه”، صدر للأكاديمي والأديب المغربي مبارك ربيع كتاب جديد يضم ثلاث قراءات في عمله الأدبي “بدر زمانه” الصادر قبل أزيد من أربعة عقود.
ويقدم الكتاب الجديد الصادر عن مطبعة دار المناهل بدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، قراءتَي جورج طرابيشي ومحي الدين صبحي لـ”بدر زمانه”، مع قراءة ذاتية لمبارك ربيع في روايته بعد أربعين سنة من نشرها.
يفسّر مبارك ربيع تضمين قراءة الكاتبِ لروايته، بالقول: “ارتأيت من باب حوار ضمني بين الإبداع الأدبي والنقد أن أقدم بدوري (معالم قراءة ذاتية) لعلها تتماس أو تتوازى على الأقل، إن لم تتقاطع في تفاعل ما، مع النقد الأدبي”.
يروي مبارك ربيع قصة نشر روايته هاته لمّا زار باريس ذات غرض دراسي، والتقى فيها بالروائيين عبد الرحمن منيف وأحمد المديني، فأخبرهما بإتمام عملٍ روائي: “ليبدي منيف رحمه الله رغبته في الاطلاع عليه، فكان أن سلمته في لقاء تال نسخة كانت معي، مسحوبة كالمعمول به في ذلك الوقت بآلية ستانسيل، وهي النسخة التي ظلت معه ولم نتحدث في شأنها بعد ذلك، رغم لقاءات متعددة في باريس والرباط، إلى أن فوجئت بعد مدة، قد تكون سنة (…) برسالة تصلني من المؤسسة العربية للدراسات والنشر ببيروت، تخبرني بما مؤدّاه أن الرصاص الذي اغتال الشهيد عبد الوهاب الكيالي، طال الرواية أيضا، لأنها كانت على مكتبه إذ ذاك، فتطايرت أشتاتا، ويطلبون مني تبعا لذلك تزويدهم بنسخة جديدة. طبعا مفاجأتي كانت مضاعفة (…)”.
وبعد صدور الرواية سنة 1983، كان “من حظها، لا سيما أنها تعتبر من أواسط مراحل إنتاجي، أن تنال اهتماما نقديا خاصا، وتصدر عنها دراسات عديدة على مستويات ثقافية وأكاديمية، مغربية، مغاربية، ومشرقية، ارتأيت أن أقدم نموذجين مميزين منها، وباختلاف منهجي لا يخلو من تكامل، لعلمَين من مفكرينا ونقادنا في المشرق العربي”.
وبرّر ربيع اختيار هاتين الدراستين أولا بـ”دلالاتهما الزمانية، إذ صدرت دراسة جورج طرابيشي سنة 1994، أي بعد مرور حوالي عشر سنوات على نشر الرواية. بينما صدرت الثانية، وهي دراسة محيي الدين صبحي، بعد حوالي عشر سنوات من الدراسة الأولى سنة 2003، وبعد عشرين سنة من صدور الرواية، وهي فترة زمانية دالة على استمرار القراءة النقدية، بما تتطلبه وتتسم به من نوعية في التحليل”.
وتابع موضحا أن معيار اختياره كان أيضا “نوعية التناول، بما يبين عنه من سمة جد وجهد، تضاهي أو تقارن على الأقل بالمبذول الإبداعي للكاتب نفسه”، ونظرا لـ”الإضاءات الوفيرة والمتميزة التي تتضمنها الدراسة، عبر تعليقات وتوضيحات ومقارنات مع نماذج روائية عربية وعالمية، مع مرجعية وافية لدراسات علمية تؤشر على العمق الفكري والأفق الثقافي النقدي”.
ويدافع الأديب مبارك ربيع على تصور لـ”مغامرة النقد” يراها تبدو “المقابلة للمغامرة الإبداعية، اكتشافيةً استكشافية عن حق، تجعل مُتناوِل الأثر الإبداعي، رغم اشتغاله على معلوم وانطلاقه من معلوم، كفيل بأن يقتنص مجاهيل في المنجز المتناوَل؛ وهي مغايرة إلى حد ما، أو هي على الأقل بعيدة عن مجرد الماثل المباشر، إلى استكناه ما قد تمثله دكنة ظلية هامشية أو خطف لمعة ضوئية على منفسح أو منغلق، مما قد يبدو ذيليا أو نافلا، بالنسبة للصورة الإبداعية الكلية، حتى ولكأن المبدع نفسه غير منتبه لها ولا واع بها، لكن النقد يجليها ويماهيها، ذاهبا بها إلى احتمالاتها الممكنة، أو جوازاتها حسب تعبير محيي الدين صبحي؛ وكأننا هنا أمام لا وعي إبداعي، لا بما يعني الجهل بالشيء من قبل المبدع، ولكن بما يؤشر على أن هذه اللمسة، تصدر عن المبدع عفوا حدسا، دون أدنى جهد أو إحساس خاص، لتأخذ موقعها الوظيفي ضمن المتحقق الكلي”.
ويخلص الروائي المغربي البارز عضو أكاديمية المملكة المغربية إلى أن “القراءة الروائية الواعية، مهما كان مصدرها، لا بد أن تنتهي بكيفية ما، إلى أن تترك الباب مشرعا لقراءات وإمكانات أخرى؛ وبمقابل مثل هذا الإقرار النقدي، الذي يترك فسحة لقراءات أخرى مكتشفة، فإن الكاتب الروائي نفسه، معرّض بطبيعة عمله، ومهما يبلغ تألقه ونجاحه، إلى أن يستشعر النقصان إزاء ما لم ينجزه بعد، وما يطمح إلى إنتاجه”.
المصدر: وكالات