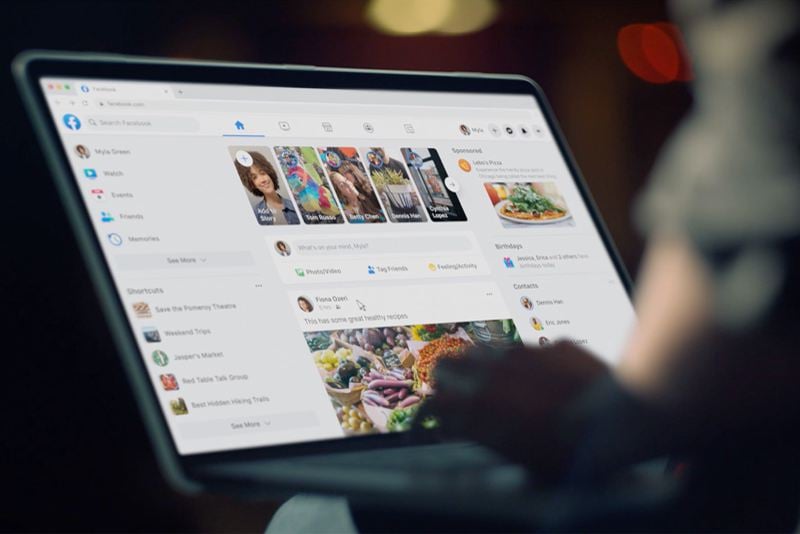قال السيميائي المغربي سعيد بنكراد إن الشّعار الحياتيّ “أشتري وأستهلكُ، وأتمتّعُ” أصبحَ بديلا للشّعارِ القديمِ الذي كان يرفعهُ المواطنون “أنتخبُ وأشاركُ، فذاك دليلٌ على حضوري، وذاك ما يشكّلُ معنى حياتي”، مضيفا أن “الصّور الجديدةَ في الإشهار وفي الكثيرِ من أشكال التّواصلِ الأخرى تَمنعُنا من رؤيةِ ما يُحيطُ بنا، لأنّها توجّهنا إلى ما يَجب أنْ نراهُ وكيف نراهُ، وما يجبُ أنْ نرغب فيه ونَتمنَّى الحصولَ عليه”.
وتطرق بنكراد، في مقال له بعنوان “الافتراضيُّ والإشهارُ المعمّم”، إلى مجموعة من الجوانب المرتبطة بالإشهار، من بينها فئة “المؤثرين” الذين قال عنهم: “لا أحدَ يعرفُ موضوعَ تأثيرِهم ومن نصّبهم في وظيفتِهم ولا الجهةَ التي يُمكنُ أنْ تَستفيدَ من تأثيرهِم”، مشيرا إلى أن الكثير منهم تحوّلوا إلى “وصلاتٍ” إشهاريّةٍ تُروّجُ لمنتجاتٍ من كلّ نوعٍ.
نص المقال:
يُشيرُ جان بودريار في كتابِه: “Simulacres et simulation”، الصّادرِ سنة 1981 إلى ما يُطلقُ عليه “الإشهارُ المطلق”. وكان يَعني بذلك ظُهورَ صيغةٍ تواصليّة جديدةٍ أفرزتها الأزمنةُ المعاصرةُ واتخذت شكلَ “إشهار معمّم” شمِل كلّ الأنشطةِ الإنسانيّة، فكلّ وسائلِ الإعلامِ وأشكالِ الاتصالاتِ وطرق العرضِ السيّاسيّ والطّقوسِ الاجتماعيّةِ وحضورِ الأفرادِ في الفضاءات الخاصّةِ والعامّةِ ليست سوى وصلةٍ إشهاريّةٍ لمنتجاتٍ من كلّ نوعٍ. لقد “ابتلعَ الإشهارُ في تصوّره كلّ الصّيغِ التعبيريّة الافتراضيّة، ما يعودُ إلى اللّغات والأشكالِ الثقافيّةِ. لقد استطاعَ فِعل ذلك لأنّه آنيٌّ وبلا عمق وسريعُ الزّوال. وقد شكّلَ ذلك انتصارا لكلّ الممارساتِ السطحيّة”.
يتعلّقُ الأمرُ بما يشبهُ العودةَ إلى حسيّةٍ في العينِ وفي اللّفظِ تلتقطُ العلاماتِ في طاقاتها الدّنيا، ما يُشكّلُ الحدّ الأدنى للمعاني أو يُشيرُ إلى صيغِ التّعيين المباشر فيها. وضمنَ هذه العلاماتِ أصبحَ الشّعارُ الحياتيُّ: “أشتري وأستهلكُ، وأتمتّعُ” بديلا للشّعارِ القديمِ الذي كان يرفعهُ المواطنون: “أنتخبُ وأشاركُ، فذاك دليلٌ على حضوري، وذاك ما يشكّلُ معنى حياتي”.
إنّها الشّفافيّةُ التي تَساوَى فيها النّاسُ في الرّغبات وفي الاستهلاك، وتَشابهتِ الـمُنتجاتُ وتلاشتِ الخصوصيّاتُ واختفى ما كان يُميّز ويفصلُ. لقد أصبحَ “الشّكلُ الإشهاريُّ هو الشّكلُ الذي يُغطّي على كلّ المضامينِ الخاصّة”. لم يَعد الإشهارُ، كما كان في زمن “الريكلام” وبعده، “يَقترحُ على النّاس مدلولا، إنّه يَكتفي اليومَ بتقديمِ معادلٍ مبسّطٍ لعلاماتٍ كان هناك قديما ما يُميز بينها”.
لقد توارتِ الجدرانُ والمباني عن الأعينِ، “ولم يَعدِ الإشهارُ هو ما يزيّنها، إنّه هو الذي يَحجُبُها اليوم عن الأنظار، إنّه يمحو الأزقةَ والواجهاتِ وكلَّ ما له علاقة بالعمران، لقد قضى على كلّ الأسْنادِ وعلى كلّ مظاهر الرّصانةِ، وذاك ما دفَع النّاسَ إلى الاستغراقِ في لحظةِ انبهارٍ غريبةٍ وعجيبةٍ، ولم يعد بالإمكان استبدالها بأيّ شيء، إنّها تُعدُّ الشكلَ الفارغَ للإغراء”. إنّها حالةٌ من حالاتِ الانصِهارِ في عوالم لا شيءَ يَربطها بحقائقَ تأتي من محيطٍ أصبحَ هو ذاتُه واجهةً لافتراضٍ يَقومُ مقامَ واقعٍ لم يعد جزءا من الحقلِ البصريِّ في العينِ، فالقليلُ من النّاسِ ينتبهون إلى تَفاصيلِه في حياتِهم.
وتلك هي الميزة الرئيسة للصّورة الإشهاريّة في السّجلّ البصريِّ الراهنِ، لقد أصبحت عابرةً للذّاكرة، إنّها، في أغلب حالات وجودِها، تنتشرُ في كلّ الفضاءِ الافتراضيِّ، فهي موجهةٌ للتّسويقِ أولا، ولكنّها موجّهةٌ أيضا إلى التّرفيهِ والتّضليلِ وخلقِ حالاتِ تداخلٍ بين ما تراه العينُ حقّا وبين ما تُوهمُ به الواجهاتُ البصريّةُ. وبذلك، خلقتْ حالاتِ خلطٍ غريبةٍ بين ما يُعرضُ في صورةٍ معزولةٍ، وبين ما يُعرضُ لغاياتٍ تجاريّةٍ محضة. فالصّور في الفضاءِ الافتراضيِّ يُلغي بعضُها البعض (لا وجودَ لنصٍّ بصريّ ثابتٍ في الإشهارِ، ولا قيمةَ لملايينِ الصّور التي تُلتقَط يوميّا، فأغلبُها لن يعرفَ طريقَهُ إلى الورقيِّ أبدا). إنّها، تبعا لذلك، لا تملكُ رهبةَ الوثَنِ ولا جِديّة اللّوحةِ، كما يقول دوبري، إنّها تَبحثُ عن أُلفةِ في العينِ تحلّ محلّ أُلفة الوجهِ الفعليِّ، أو تَقوم مقامَ “حقيقةِ” الشّيءِ في العالمِ الخارجيِّ. إنّها بذلك تَضعُ دائما قدْرا من السُّخريّة والعبثِ والعرَضيّة في الأشياءِ التي تمثُّلها.
بعبارةٍ أخرى، إنّ هذه الصّور الجديدةَ في الإشهار وفي الكثيرِ من أشكال التّواصلِ الأخرى، تَمنعُنا من رؤيةِ ما يُحيطُ بنا، لأنّها توجّهنا إلى ما يَجب أنْ نراهُ وكيف نراهُ، وما يجبُ أنْ نرغب فيه ونَتمنَّى الحصولَ عليه. إنّها لا تُخبرُ عن حقيقةِ ما تقومُ بتمثيلِه، إنّها تُعيدُ صياغتَه وفق ما تودّه انفعالاتُ المتلقي/الزّبون/المستهلك. لقد كانت العينُ، قبل انتشارِ صورِ الإشهارِ في كلّ مكانٍ، وقبل تعميمِ حالاتِ الافتراضِ البصريّ، حرةً في التّصرفِ في عوالِمها، كانت تختارُ موضوعَ نظرتِها وتختارُ زوايا النّظرِ إليهِ. وها هي الآن أسيرةُ ما يُعرضُ عليها في كلّ مكانٍ، إنّها لا تَنظرُ، إنّها تكتفي باستقبال ما يُعرضُ عليها. فكلّ ما يَنتمي إلى الواقعِ تَوارى إلى خلفٍ لا أحدَ يُدركُ مَداهُ. إنّ الوهمَ يُغطّي اليومَ على الواقعِ، ولكنّ الواقعَ ذاتَه في انحسارٍ دائمٍ، لذلك “أصبَحَ الوهمُ مستحيلا، لأنّ الواقعَ هو الآخرُ أصبحَ مستحيلا”.
لذلك سيَعرفُ الإشهارُ تحوّلا جذريّا مع عصرِ الرقميّةِ. سيتمُّ ذلك في المادّةِ وفي أساليبِ العرضِ وفي أدواتِ الإقناعِ أيضا. لقد تغيرت طبيعةُ الصّورة، وتغيّرت حالاتُ النّظرِ داخلَها. فلم تَعد العينُ “تَرى”، كما كانت تَقتَضي ذلك قواعدُ الفُرجةِ التّقليديّةِ، إنّها الآنَ تتأمّلُ ذاتَها داخلَ “فُرجةٍ” افتراضيّةٍ لا تَستندُ إلى نظرةٍ تُعيدُ بناءَ ما تراهُ، بل تَلهثُ باستمرارٍ وراءَ تمثيلاتٍ مباشرةٍ “لانفعالاتٍ” بصريّةٍ لا ترتبطُ، في غالب الأحيان، بلحظةٍ فريدةٍ مُنزاحةٍ عن دفْقٍ زمنيٍّ مألوفِ. إنّها تَتشبّثُ بالعابرِ في الزّمنِ وفي الجسدِ المصوَّرِ وفي عرضِ المنتجاتِ على حدّ سواء. فما يَحدثُ في المعيش اليوميّ لا يُشبهُ إلا قليلا ما يُفكّر فيه النّاسُ أو يمارسونَه في حقيقةِ حياتِهم اليوميّةِ.
واستنادا إلى ذلك سيُصبحُ موضوعُ الرّغبةِ، أيْ ما يُمكنُ أنْ يَشتغلَ كحافزٍ للاستهلاكِ، هو ذاتيّةُ المبحرِ نفسُها. “فقد أُعيدَ النّظرُ في مفهومِ الاستهلاكِ ذاتِه، فلم يَعد لحظةً عارضةً في حياةِ النّاسِ، ولم يعد يَتحقّقُ على هامشِ أحلامِهم أو رغباتِهم، بل أصبحَ هو ما يُحدّدُ جوهرَ كينونتِهم. لقد استوْلى هذا الفضاءُ على كل عوالمِ الإنسانِ، لقد ابتلعَ الموضوعاتِ الإشهاريّةِ وابتلعَ قارئيها دفعةً واحدةً، وأصبحَ الفضاءُ الإنسانيُّ داخلَه ساحةً لا متناهيّةً لاستهلاكِ كلّ شيءٍ. فكلّ من يَدبُّ في الأرضِ ليسَ سوى موضوعٍ إشهاريٍّ قابلٍ للبيعِ”. وهكذا لم يَعد الإشهارُ “فاصلا” نَعودُ بعدَه إلى عالمِ الفنِّ أو التّواصلِ، لقد تحوّلَ كلُّ شيءٍ إلى وصلةٍ إشهاريّةٍ لا تَنتهي أبدا. وهناك الكثيرُ من البرامجِ التلفزيّةِ ليستْ سوى وصلاتٍ إشهاريّةٍ تُروِّجُ لمنتجاتٍ من كلّ الأنواعِ.
ويَكفي أنْ نَستحضِرَ في هذا السيّاق برنامجا رمضانيّا قدمتهُ القناةُ الثانيّةُ في المغرب على امتدادِ سنواتٍ بعنوان “مْشيتي فيها” (وهو بالمناسبة حصّةٌ ترفيهيّة لا ترفيهَ فيها)، إنّه نموذجٌ لما صنّفه بودريار ضمن “الإشهار المطلق”. يتعلّق الأمرُ بدعايةٍ مدفوعة الأجرِ لمُنتجعات أو فنادقَ أو مناطقَ ترابيّة بأكملِها. فلا يَقولُ هذا البرنامجُ أيّ شيءٍ، ولا يعالجُ أيّ قضيةٍ، إنّه يُحاكي “الكاميرا الخفيّة” التي كانت الغايةُ منها اختبارَ رُدودِ أفعالِ النّاس العفويّة، في لحظات معدودةٍ ومحدودةٍ. لقد استعانَ هذا البرنامجُ بممثلينِ كانوا على علمٍ مسبقٍ بكلّ المقالبِ التي يَتظاهرُ المعدُّ بِنصبِها لهم، وكانت الكاميرا تَتحركُ وفق ما يودّه المستشهرُ، لا إلى ما يمكنُ أنْ يقودُ إلى خلق حالة توتّر في الأداءِ والقصّةِ. يبدو أن “الحصة الترفيهيّة” ليست سوى وصلةٍ إشهاريّة.
إنّنا نعودُ من جديدٍ إلى ما كان بودريار قد كتبَه سنة 1970. فقد تحدّثَ حينها عن الإشهارِ باعتبارهِ يَندرجُ ضمن “إيديولوجيّة الهِبة” التي تَشملُ كلَّ الخدمات المجانيّة، وما يُحيطُ بعملياتِ التّسويق. بل قد تَتّخذُ شكلَ “تخفيضاتٍ” و”تكسيرٍ للأثمان” و”هدايا صغيرة”، كتلك التي تُقدّمها المؤسساتُ الاقتصاديّةُ إلى زبائِنها. ووفق هذه الإيديولوجيا المقنعة، “فإنّ الإشهارَ كلّه ليس سوى تَعميمٍ شاملٍ لهذا “الشّيء المضاف” (…) ووفق ذلك سيصنّفُ الإشهارُ ضمن قطاعِ العلاقاتِ العامّةِ”. إنّه يُوهمُ المستهلكَ أنّه محلّ عنايةِ البائعِ أو الذي يُقدّمُ خدماتٍ. ومن خلالِ فعلِ الهبةِ هاته يَستيقظُ الطّفلُ الصغيرُ داخلَ المستهلكِ الكبيرِ، ويَفرحُ بكلّ “الغاجات” (gadjets) التي يَحصلُ عليها لَحظةَ الشّراءِ.
لم تعد هناك فواصلُ بين ما يَعود إلى تفاصيل حياتيّةٍ تُعاش وفق إكراهاتِ العملِ والالتزاماتِ العائليّة (لا يكفُّ النّاسُ عن العبث بهواتِفهم في كلّ مكانٍ)، وليس هناك فاصلٌ بين عَوالمِ الصغارٍ والكبارِ، وبين عوالمِ الجِدّ والهزلِ، بين لحظاتِ العملِ والاسترخاءِ. لقد أصبحَ عالمُ الافتراضِ، وعالمُ الحواسيبِ واللّوحات وكل “الغاجات” التي يتداولُها النّاسُ شبيها بديسنيلاند، أو بكلّ الحدائقِ الصبيانيّةِ التي يَتعلّمُ من خلالِها الأطفالُ كيفَ ينتمونَ إلى ثقافتِهم. “فهذه العوالم تُريدُ أن تَكون صبيانيّةً لكي تُوهمَ النّاسَ بأنّ الرّاشدينَ يُوجدون خارجَها، أي في العالمِ “الواقعيِّ”، ولكنّها في حقيقتها تُحاول ُإخفاءَ أنّ الصبيانيّةَ الحقيقيّةَ تنتشِرُ في كلّ مكانٍ، وأنّ صبيانيّةَ الكبارِ أنفسِهم هي التي تُعرضُ على الطّفلِ، فهي صبيانيّتهُم الحقيقيّة”.
ووفق هذه الصبيانيّةِ أو بوحيٍ منها أفرزَ الافتراضيُّ كائناتٍ جديدةٍ موزّعةٍ على أنشطةٍ مختلفةٍ فيها التّهريجُ والتّضليلُ ونشرِ الأباطيلِ وتسويغِ ما لا يمكنُ تسويغُه بمنطقِ العقلِ. يتعلّقُ الأمرُ بفئةٍ جديدةٍ خرجتْ من ثوبِ المحتجِّ والمناضلِ والمهرّج والهامشيّ. إنّها فئة “المؤثرين”. فلا أحدَ يعرفُ موضوعَ تأثيرِهم ومن نصّبهم في وظيفتِهم ولا الجهةَ التي يُمكنُ أنْ تَستفيدَ من تأثيرهِم. وما يشدُّ انتباهنا هنا هو الجانبُ الإشهاريُّ في نشاطِ هؤلاء “المؤثّرين”. فقد تحوّلَ الكثيرُ منهم إلى “وصلاتٍ” إشهاريّةٍ تُروّجُ لمنتجاتٍ من كلّ نوعٍ: المطاعمُ والفنادقُ والحاناتُ. ستكونُ قيمةُ هذه المؤسّساتِ مستمدةٌ من قيمةِ “المؤثر”، فوجودُه فيها دليلٌ على جودتِها.
وتلك مفارقةٌ كبيرةٌ في التّاريخِ المعاصرِ. فبينما كان النّموذجُ القديم للبطلُ فنّانا ومناضلا ومقاوما داعيّا إلى السّلمِ والحبِّ، لقد كانَ في جميعِ هذه الحالاتِ كائنا اجتماعيّا يَدعو إلى قيّمٍ أو يُبشر بأحلام تُوزَّعُ على جميعِ النّاس، وكان يَتحرّكُ في فضاءٍ وزمانٍ معلومين، فإنّ “المؤثّر” يبدو مرتبطا باللّحظةِ، فلا أرضَ لهُ ولا هويّةَ ولا مبدأَ، إنّه هنا لكيْ يَستثيرَ انفعالاتٍ عابرةٍ، إنّه يبيعُ “لوكًا” خارجيّا، أو يَعتمدُ في الغالبِ الأمامَ والخلفَ في مؤهّلاتِ الجسدِ وحدها، في حالة “المؤثرات”. “وذاك هو الحدُّ الفاصلُ بين إنسانيّةٍ تَنتشِرُ في الزمنيّةِ، وبين عيشٍ لحظيٍّ بلا أفقَ لا يُعيدُ إنتاجَ سوى نفسِهِ”.
لقد استُدرجَ النّاسُ، جميعُ النّاسِ، البَاحثونَ عنِ العلمِ والبَاحثونَ عن المتعَةِ والبَاحثونَ عن الفضائح، إلى الفضاءِ الافتراضيّ، لقد تحوّلوا جميعهُم إلى “موادَّ” استهلاكيّة معروضةٍ على الـمُبحرين وعلى العيونِ المتلصّصةِ. إنّهم يُستَهلَكونَ ويَستهلِكون، يُستهلكون “كبياناتٍ” وانفعالاتٍ” و”روائز” و”موضوعاتٍ”، ويَستهلِكون ما تُقدِّمهُ لهم الوصلاتُ المتقطّعةُ التي تَتخَلّلُ البرامجَ والأفْلامَ والمسلسلاتِ، ولكنّهم يَستهلِكون أيضا أوهامَهم واستيهاماتِهم ومعاركَهم الدونكيشوتيّة. وبذلك أصبحَ الإشهارُ وكلّ الفضاءاتِ التي تحتضنُه آلةَ رقابةٍ رهيبةٍ لا تُصادرُ الرأيَ المخالِفَ فحسب، بل تَـتعرّفُ على أشدِّ المناطقِ حميميةً في الإنسانِ، وعلى كلّ ما استعْصى على العيونِ الأمنيّةِ.
وهكذا “لم تَعد الأشياءُ تُشكّل مُنتجاتٍ مستقلّةٍ، ولم تَعد علاماتٍ يمكن إدراكُ فحواها، إنّها في واقع الأمر روائز، وهذه الرّوائزُ هي الواسطةُ بينَنا وبين عالمِنا، فهي التي تُسائِلنا وتضطرّنا إلى الاستجابةِ إليها، فالجوابُ مدرجٌ دائما في السؤالِ”. لقد حاصرونا بكلّ ما نحن في حاجةٍ إليه وبكلّ ما لم نكن أبدا في حاجةٍ إليه. وضمن ذلك كبّلونا بـ”عقودٍ إذعانيّةٍ” لا أحدَ من المستهلكين يقرأُها أو ينتبهُ إليها، إنّنا نُسارع إلى التّصديقِ عليها لكي نُبحرَ في الفضاءِ الافتراضيِّ تحت رقابةِ الغافام ووفق توجيهاتِ خوارزميّاتها. وبذلك مكنّاهم من كل شيء في حياتنا. فجزءٌ كبيرٌ من المعلوماتِ الخاصّة بالمستهلكين يُباع جهارا، باعتبارهِ منتجاتٍ من نوعٍ مخصوصٍ إلى الشّركاتِ الخاصّةِ لكي تَستعملَه في البحثِ عن زبائِنها، وجزءٌ آخرَ منها يُوجّهُ إلى مصالحِ الاستخباراتِ في الدّولِ الكبيرةِ والصغيرةِ على حد سواء.
لقد تحوّلَ المبحرونَ أنفسُهم إلى كائناتٍ بلا بوصلةٍ زمنيّة أو فضائيّة، لقد خرجوا من دُنيا النّاس التي كان يُقاس عليها حضورُ الفردِ أو غيابِه لكي يَلجوا دُنيا افتراضيّة هي الدّليلُ الوحيدُ على وجودِهم (يسأل المبحِرُ صديقَه في الشّارع العام: أين اختفيت لم نَعد نراك أو نَسمعُ عنك أيّ شيء). يتعلّق الأمر بـ”تشخيصٍ” موجّهٍ للفضاءِ الواقعيّ، فالمجتمعُ في تصوّر الغافام مريضٌ، والمستهلكُ هشٌّ والقلقُ يُحيطُ بالنّاسِ من جميع الجوانِبِ، وليس هناكَ سوى “الإشهارِ المعمّمِ” من أجل القضاءِ على كلّ الأمراضِ، أو على الأقلّ التّخفيفَ من آلامِها، حينها يُصبحُ الاستهلاك كاتارسيسا، تطهيرا للنّفس وتخليصَها من إكراهاتِ الواقعِ وتعقيداته من خلال الخضوع له والتقيُّدِ بما يريدُه الحاكمون.
لقد جعلَ الافتراضيُّ من كلِّ النّاسِ أبطالاَ في كل الميَادين: إنّهم كتّابٌ وفقهاءٌ ومطربونَ ومناضلونَ من أجلِ كلّ شيءٍ، الحقيقيِّ منه والمزيفِ والواقعيُّ منه والوهميّ. لقد تحوّلَ الفضاءُ الافتراضيُّ إلى ساحات استهلاك لا ينضبُ، فهو متجرٌ كبيرٌ تباعُ فيها كلَّ السّلعِ: الأخبارُ الـمُزيّفةُ والإشاعات والفضائح وقليلٌ من حقائقِ الوجودِ. وهكذا لم تَعدِ الأشياءُ دالّة على شيءٍ آخرَ غير نفسِها، تماما كما تحولتِ اللّغةُ التي تَصفها إلى مستودعٍ لملفوظاتٍ تقريريّةٍ تَكتفي بوصفِ ما تراهُ العينُ، أيْ وسيط أو أداة عابِرة في ذاكرةِ النّاسِ وفي ذاكرةِ الأشياءِ التي تَصفُها أو تُسمّيها. لقد أصبَح النّاس” يَعيشُون في عالمٍ تَنتشر فيه الأخبارُ أكثرَ مما تملأُه المعانيّ”. وضمن هذا الإبدالِ الاستهلاكيّ المعمّم، انتشرت لغةٌ هجينةٌ ينتقلُ فيها المتكلّمُ ضمن سجلاتٍ متنوعةٍ، ويَتحكّمُ فيها استعمالٌ دارجٌ يَزدَري كلّ تفكيرٍ عميقٍ.
واقعُ الحالِ هذا حوّل معطياتِ النّاسِ إلى منتجاتٍ تُباعُ في أسواقَ لا تُغلَقُ أبوابُها أبدا، إنّها مفتوحةٌ في عالم افتراضيِّ يَبيعُ للنّاسَ كلّ ما يبحثونَ عنه، أيْ ما تودّه “الغافام” وتُبيحهُ برمجيّاتها التي تتحكّمُ في مصائر النّاسِ وتُوَجّهها نحو ما يُلبّي غاياتٍ تسويقيّةٍ. تتضمّنُ هذه المُعطياتُ حقائق تعودُ إلى طريقةِ استهلاكِهم وطريقةِ ادّخارهِم وكيفيّة قضاءِ عطلِهم ومشاريعِهم الآنيّةِ والآتيّةِ وما يحلمون به. وتتضمّن أيضا صورَهم: أيْ بورتريهات “حقيقيّة” تقولُ الكثيرَ عن هويّتِهم في الحقيقةِ والافتراضِ. إنّها نسخةٌ فعليّةٌ يُمْكنُ من خلالها قراءةُ مناطقَ شاسعةً في كيْنونتِهم، ما يعود إلى ميولاتِهم وإلى رغباتِهم وأحلامِهم واستيهاماتِهم ومواقِفهم في السيّاسةِ والدّين والاجتماعِ. فلم يَعد الاستهلاكُ موجّها إلى سوقٍ تُروّجُ سلعا حقيقيّةً، بل أصبحَ يَعتمدُ معطياتٍ معروضَةٍ بسخاءٍ في الفضاءِ الافتراضيِّ هي ما تعتمدهُ الكثيرُ من الجهاتِ في توقّعُ ما يرغب النّاسُ في استهلاكهِ وما يُمكنُ أنْ يصدرَ عنهم في المديَينِ القريبِ والبَعيدِ.
وهكذا “أصبحَ شدّ انتباهِ المُبحرِ هو الهمُّ الرئيسُ للإشهارِ الرقميِّ، فمن خلالهِ تَتحدّدُ فعاليّتُه في مُؤشراتِ المشاهدةِ”. إنّ الوصلةَ من خلال ذلك تَتواصلُ مع كلّ فردٍ باعتبارهِ واحدا لا جزءا من مجموعةٍ. فالإبحارُ فرديٌّ دائما، إنّ المبحرَ يُواجهُ معزولا عالما أزرقَ لا أحدَ يُرشدُه غير ما تَقترحُه عليه الخوارزميّات. و”ضمنَ هذه الأشكال الجديدة أصبحَ المستهلكُ هو من يذهبُ إلى الرّسالةِ وهو من يبحثُ عنها، ولكنّ الرسالةَ ذاتَها تخلّصت في هذه الأشكالِ من كل إبداعيّةٍ فنيّةٍ لكي تتحوّلَ الى مجرّدِ ‘ريكلام’ واضحٍ من السّهلِ إدراكُ فحواه”.
بعبارةٍ أخرى، “لا يتعلّق الأمرُ في الإشهارِ الرّقميِّ بالقذفِ بالمستهلكِ في عالمٍ رمزيٍّ، كما كان يَتصوّرُ ذلك بارث، بل يتعلّق بشدّ انتباهِه إلى منتجٍ بعنيه”، وتبعا لذلك “تحوّلَ المستهلكُ نفسهُ إلى موضوعٍ للشّراءِ ولم يعد مجرّد “ما تبقى من الزّمنِ عندهُ”، يُعرض على المشاهدِين في منازلِهم، إنّه ما يَـمُدّ الغافام بكلّ المعطياتِ”.
لقد أصبحتْ كلّ المنتجاتِ المتداولةِ مجرّدَ نسخةٍ لا قيمةَ لها قياسا إلى ما يُمكنُ أنْ يُعرضَ في الصّور، فهي وحدها الحقيقيّةُ، فهي النّموذجُ. إنّ الأصلَ موطِنُه الصّورةُ في اللّوحاتِ الإشهاريّة، وفي فيديوهات “يوتيوب”؛ فبِمجرد ما تُقدم الشّركات شكلا جديدا، في الصّورة دائما، يُسارعُ النّاس إلى التّخلّص من النّسخَة التي يملكونَها من أجل الحصولِ على نسخةٍ جديدةٍ تكونُ أقربَ إلى النّموذجِ الكلّي الذي تَضعه الصّورة للتّداولِ. وفي جميع الحالاتِ سيَظل النّموذجُ مستعصيا على الامتِلاك، إنّه البؤرةُ التي تُولد فيها الرّغباتُ وفيها تموتُ أيضا (لنتذكّر الطّوابيرَ الطويلةَ في المدنِ الغربيّة الكبيرة من أجلِ اقتناءِ أيفون 5 أو أيفون 6).
وهذا معناه أنّ الحاجاتِ لا يجبُ أنْ تُلبّى، إنّ إشباعَها منافٍ لطبيعة مجتمعِ الوفرةِ، فلم تعدِ الوفرةُ ليست بضائعَ تُعرض في الأسواقِ، لقد تحوّلت إلى حالةٍ نفسيَّةٍ اجتماعيةٍ ترهنُ الفردَ إلى الاستهلاك. لقد أصبحَ الإنسانُ أسيرَ ما يُنتِجُ، لقد فقدَ روحَه وبصيرتَه وتحوّل إلى كينونةٍ عاريّةٍ من كلِّ قيمةٍ. لذلك يَقوم الإشهارُ بالتّلويحِ دائما بعالم استهلاكيٍّ آتٍ يُلغي ما هو متوفّرٌ. فالمُنْتَجات تُغادرُ مخازنَها لتأتِيَ إلى عينِ المسْتهلكِ في شكلِ صورٍ هي الصّلةُ الأولى وربّما الأخيرةُ بين الـمُنْتَجِ والمستهلكِ. فكما هو البطلُ المعاصرُ لا يملِكُ سوى جسدِه، فهو ما يسكنُ انفعالات المعجبين بهِ، إنّه الواجهةُ الوحيدةُ المعروضةُ في الصّور، فإنّ البضائعَ يجبُ أنْ تُغيّرَ من شكلِها ولونِها لتُصبحَ مظهرا يَمنحُها هويّةً مختلفةً هي ما يُباعُ للزبائنِ (أغلبُ الهواتفِ لها الوظائفَ نفسَها، ولكنّ المصنِّع يُوهم النّاس بأنّ 5 أحسن من 4 في الوظائِف لا في التّسلْسل).
لقد تخلّصت الرأسماليّةُ من المواطنين ومُتطلباتهم، وانتصرتْ على المجتمعِ وأفرغتْ مؤسّساتِه السياسيّة من مضمونِها، وقلّلت من شأن المثقفِين ومن مواقفهم ورغبتِهم الدائمة في مراقبةِ الدولةِ وطريقتها في تدبيرِ شؤونِها في السياسةِ والاقتصادِ، واستبدلتهم بمستهلكين طيّعين تُحركهم الرّغباتُ الحسيّةُ وحدها. وكما هو الحالُ مع شركاتِ التّدبير المفوّضِ التي انتشرت في كل مُدنِنا، فإنّ هناك أيضا المنصات الجديدة التي أصبحتْ هي ما يتكفّلُ بشؤونِ المستهلِكين وهي ما يُوجِّههم إلى طريقةِ إنفاقِهم وادخارِهم وطريقةِ تدبيرِ صحّتهم ومرضِهم.
المصدر: وكالات